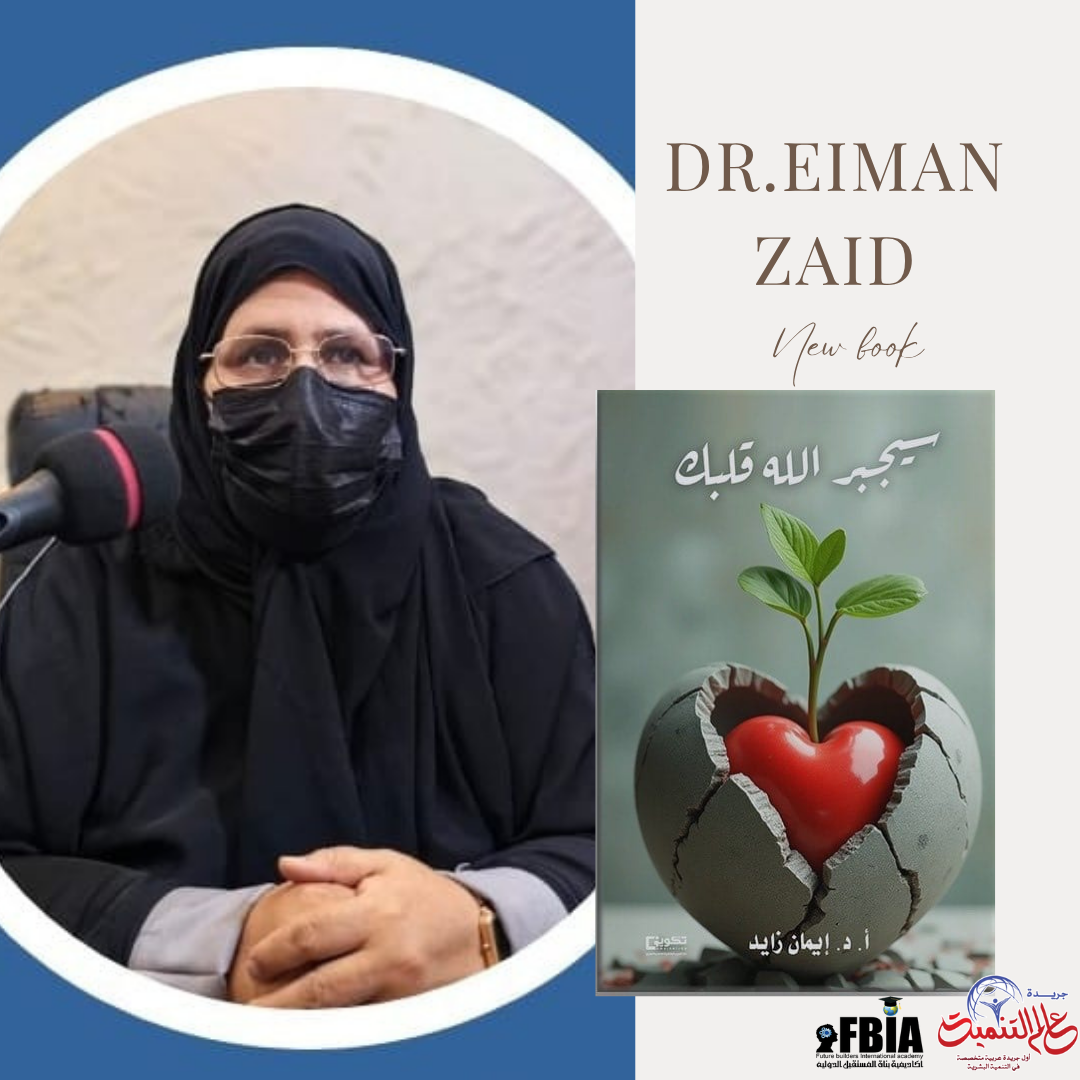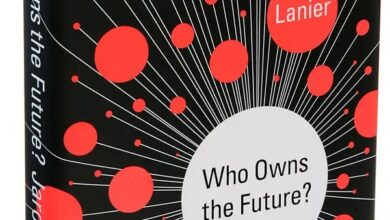الجزء الثاني من تلخيص كتاب “ممارسة الأداء ” تأليف :هنري مينتزبيرج
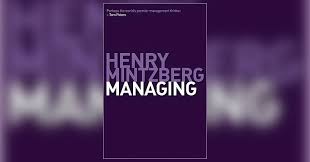
“ممارسة الأداء ”
إستخدام نموذج عام للإدارة
يضع هذا النموذج المدير في مركز وسط بين دورين، أي بين الدور الذي يضطلع به رسميًا داخل القسم (ما لم يكن مديرًا تنفيذيًا مسؤولاً عن الشركة بأكملها) وبين كل ما يرتبط بهذا القسم في العالم الخارجي (العملاء والشركاء، إلخ).
يتمثل الهدف الأساسي للإدارة في ضمان تأدية القسم لمهماته الرئيسة، سواء أكان ذلك بيع المنتجات في أحد المتاجر أو الاعتناء بكبار السن في إحدى دور المسنين، مما يتطلب اتخاذ أفعال هادفة ومؤثرة.
وعادةً يتولى موظفو القسم هذه المهمة، كلٌ حسب تخصصه، ولكن هذا لا يعني ألا يمارس المدير هذا الدور أيضًا.
إلا أن الأكثر شيوعًا على الرغم من ذلك هو أن يبتعد المدير خطوة أو اثنتين عن هذا الدور. فعندما يبتعد خطوة، فإنه يشجع الموظفين الآخرين على الفعل واتخاذ القرار والتنفيذ، بمعنى أنه ينجز العمل مستعينًا بموظفيه بعد تدريبهم وتحفيزهم وتشكيل
فرق منهم وبناء ثقافة مؤسسية قوية. وعندما يتراجع خطوتين، فإنه ينجز العمل باستخدام المعلومات المتوفرة لديه لدفع الموظفين إلى الفعل، بمعنى أنه يفرض هدفًا معينًا على فريق البيع، أو ينقل تعليقًا معينًا من أحد المسؤولين الحكوميين أو الشركاء الخارجيين إليهم. وهذا يعني أن العملية الإدارية تتم على ثلاثة أصعدة، بدءًا من المجرد إلى الملموس وهي: المعلومات والأفراد والتنفيذ المباشر.
يؤدي المدير دورين في كل صعيد. ففي صعيد المعلومات، يكون دور المدير هو التواصل (داخل الشركة وخارجها) والرقابة (داخلها). وفي صعيد الأفراد، يكون دوره القيادة (داخل الشركة) والترابط والتواصل (خارجها). وفي صعيد التنفيذ المباشر، يكون دوره إنجاز المهمات (داخل الشركة) وعقد الصفقات (خارجها). وسنستعرض الأصعدة الثلاثة بالتفصيل.
أولا : الإدارة بالمعلومات
الإدارة بالمعلومات تعني أن تكون بعيدًا بمقدار خطوتين عن الهدف، فتحلل المعلومات ولكن تترك لموظفيك اتخاذ الإجراءات والأفعال
الضرورية بناءً على هذه المعلومات المتاحة لهم. بعبارة أخرى، لا يركز المدير في هذا الصعيد على الأفراد ولا على التنفيذ، بل يوجه تركيزه إلى تحليل المعلومات كسبيل غير مباشر لإنجاز الأعمال. المفارقة هنا هي أنه على الرغم من اندثار هذه النظرة الإدارية الكلاسيكية التي كانت سائدة في القرن الماضي، فقد عادت من جديد بسبب اللهاث وراء جني الأرباح ورفع قيمة الأسهم، وكلاهما هدفان يحثان على الممارسات الإدارية المنعزلة القائمة على المعلومات وحسب.
ثمة دوران يرتبطان بالإدارة في صعيد المعلومات، أحدهما هو ”التواصل“ وهدفه تيسير تدفق المعلومات من المدير وإليه، والآخر هو ”الرقابة“ وهدفه استخدام المعلومات لتوجيه سلوكيات الموظفين داخل القسم. يعتبر الدور التواصلي بمثابة غشاء أو غربال حول
المدير تمر من خلاله جميع الأنشطة الإدارية. والتواصل لا يقتصر على معناه الحرفي، ولكنه وسيلة تُستخدم لإنجاز الأعمال الإدارية. فالمدير يستقبل المعلومات بفضل أنشطة المتابعة التي تجعله بمثابة المركز العصبي للقسم، كما يرسل معلوماته عن طريق أنشطة تبادل المعلومات (داخل الشركة) وأنشطة تمثيل الشركة (خارجها).
❂المتابعة: في هذا الدور، يجمع المدير كل معلومة مفيدة عن العمليات الداخلية والأحداث الخارجية والاتجاهات الاقتصادية؛ بالإضافة إلى المعلومات التي يستقبلها بفضل شبكة علاقاته الخارجية.
❂المركز العصبي: لكل موظف دور متخصص يجعله يضطلع بأداء جانب محدد من مهمات القسم. أما المدير، فيملك معرفة عامة غير متخصصة ويتولى دورًا إشرافيًا وحسب. فهو لا يعرف القدر الكافي عن تخصص معين مقارنةً بالموظف المكلَّف به، ولكنه يعرف أكثر من هؤلاء الموظفين عن الشكل العام لجميع التخصصات معًا، فهو المركز العصبي للقسم لأنه يملك المعرفة الأوسع والصورة الأشمل بسبب ما يملكه من معلومات.
❂تبادل المعلومات: يستفيد المديرون من كم المعلومات الهائل الذي يجمعونه، ويتضح هذا في ممارستهم لبقية أدوارهم الأخرى. وفيما يخص هذا الدور، فهم ينقلون المعلومات إلى موظفي القسم، أو يتبادلونها معهم. فهم كالنحل يتلاقحون
بالأفكار.
❂تمثيل الشركة: يتبادل المدير المعلومات خارج الشركة أيضًا، سواء عبر موظفي القسم إلى أطراف خارجية، أو بين الأطراف الخارجية وبعضها، مثل العملاء والموردين والمسؤولين الحكوميين. وبصفته المتحدث الرسمي باسم شركته، يعتبر المدير ممثلاً لها أمام العالم الخارجي، حيث يتحدث إلى مختلف الأطراف نيابةً عنها، ويدافع عن أهدافها وقضاياها، ويعرض تجاربها وخبراتها في المنتديات والمحافل العامة، ويبلغ المساهمين الخارجيين بأحدث المستجدات وتطورات الأوضاع.
المهارات الشفوية والبصرية والوجدانية
فائدة المدير لا تكمن فقط في تبادل المعلومات الموثقة المتاحة للجميع، ولكن في تحليل المعلومات في صورتها الأولية غير الموثقة والتي يتم تبادلها عن طريق الأقاويل والشائعات والآراء. وفي الواقع، فإن معظم المعلومات التي يحصل عليها المدير ليست شفهية بقدر ما هي بصرية ووجدانية وشعورية، بمعنى أنها مرئية ومحسوسة أكثر من كونها مسموعة، مما يؤكد أن الإدارة فن ومهارة أكثر منها علمًا. المديرون المتميزون يفهمون المعاني الكامنة وراء نبرة الصوت وتعبيرات الوجه وفك شفرات لغة الجسد والحالة النفسية.
❂التصميم: هو الوظيفة الجوهرية في الإدارة، ويعني التدخل لتنفيذ شيء ما أو تغييره. أحيانًا يضع المديرون تصميمات لأشياء ملموسة، مثل تصنيع منتج جديد أو تطوير منتج قديم. وما يهمنا هنا هو تصميم البنية التحتية للقسم من خلال استراتيجيات وهياكل ونظم عمل معينة للتحكم في سلوك الموظفين.
▼تصميم الاستراتيجيات: المدير أشبه بمهندس يرسم التصميمات على الورق كي يبدأ الآخرون البناء. وإذا تحدثنا بلغة الإدارة
الاستراتيجية، فالمدير هو المسؤول عن تشكيل الاستراتيجيات التي ينفذها الآخرون. هذا يعني أن تشكيل الاستراتيجيات عملية مقصودة وهدفها التحكم في سلوك الموظفين.
▼تصميم هياكل العمل: يقسِّم المدير المهمات ويوزع المسؤوليات على الأفراد، مع الحرص على تنظيمها حسب الهيكل الإداري. وتساعد هذه الهياكل في تنظيم وقت كل موظف وأهدافه.
▼تصميم نظم العمل: يتولى المدير مسؤولية تصميم نظم إدارية متنوعة، وأحيانًا إدارتها كذلك، وهذا يشمل الخطط والأهداف وجداول المواعيد والميزانيات ومعايير الأداء وما شابه ذلك.
❂التفويض: يفوِّض المدير مهمة معينة إلى موظف معين. هذه العملية ترتكز على المرحلة الأولى من عملية اتخاذ القرار. فعندما يريد المدير تنفيذ عمل ما، فإنه يترك أمر اتخاذ القرار بشأنه وتنفيذه إلى شخص آخر (مع الاحتفاظ بحق الموافقة على القرار النهائي).
❂التكليف: إذا كان التفويض يركز على المرحلة الأولى من اتخاذ القرار، فإن التكليف – والموافقة على القرار الذي يتخذه الموظف – يركز على المرحلة الأخيرة، وهي تحديد خيارات بعينها.
أحيانًا يرتبط هذا بأمور تطرأ ويمكن إنهاؤها بسرعة، مثل رفض المدير اقتراح قدمه أحد موظفي القسم أو موافقته عليه. فمن حقه أن يراجع خيارات الموظف، وأن يشترك في عملية اتخاذ القرار بما يملك من معلومات وخبرة، وأن يذكر له إيجابيات وسلبيات القرار الذي اتخذه كي يساعده في إيجاد حلول بديلة أو حلول أفضل.
❂توزيع الموارد: يعتبر تخصيص الموارد وتوزيعها صورة من صور التكليف، لكنه يتطلب اهتمامًا منفصلاً ومكثفًا نظرًا لأهميته في العمل الإداري. يقضي المديرون جانبًا كبيرًا من وقتهم في دراسة ميزانياتهم لضمان حسن توزيع مواردهم من الأموال والمواد الخام والمعدات، علاوة على جهود الأفراد. هذا بالإضافة إلى الأساليب الأخرى التي يتبعونها لتوزيع الموارد، ويتجلى هذا مثلاً في كيفية تنظيم أوقاتهم ومواعيدهم وتصميم الهياكل المؤسسية التي تساعد الآخرين في تنظيم أوقاتهم كذلك.
❂الإدارة بالأهداف: هذه صورة من صور الرقابة، ويُقصد بها فرض أهداف معينة على الموظفين ومطالبتهم بإنجازها، مثل زيادة المبيعات بنسبة ٪10 ، أو تخفيض النفقات بنسبة 20 ٪. فالمدير يحدد الأهداف، ثم يترك أمر تنفيذها للموظف. أحيانًا تكون هذه الأهداف بعيدة كل البعد عن الاستراتيجيات الموضوعة، لهذا يفضَّل ألا يُستخدم أسلوب الإدارة بالأهداف إلا إذا كان المدير يفتقر إلى إطار استراتيجي واضح.
ثانياً : الإدارة بالأفراد
الإدارة بالأفراد تعني أن تقترب من تنفيذ العمل بنفسك بمقدار خطوة واحدة، ولكنك تبقى منفصلاً عنه. فالمدير يساعد الموظفين في تنفيذ المهمات، ولكنهم يبقون هم وحدهم المنفذون. يتطلب هذا اتباع منهج مختلف عن الإدارة بالمعلومات؛ إذ تصبح
أنشطة المدير أدوات مساعدة، مستخدمًا كل ما يملك من معلومات لدفع الموظفين إلى تحقيق أهداف معينة. الجدير بالذكر أن الموظفين في هذه الحالة لا يشعرون أنهم يتلقون تعليمات بقدر ما يتلقون تشجيعًا لتحقيق أهداف يسعون هم أنفسهم وراءها.
❂تحفيز الموظفين: يحرص المديرون على مساعدة موظفيهم على ممارسة السلوكيات الإيجابية والفعالة. فهم يحمِّسونهم ويقنعونهم ويساندونهم ويشجعونهم. بعبارة أخرى، يحاول المديرون التنقيب والكشف عن منابع الطاقة والحماس الموجودة بالفطرة داخل الموظفين.
❂تنمية قدرات الموظفين: يحرص المديرون على تدريب الموظفين وتوجيههم وتنمية مهاراتهم واستثمار إمكاناتهم. إلا أن أكثر ما يهتمون به هو مساعدة موظفيهم في تنمية مهاراتهم بأنفسهم.
❂تشكيل فرق عمل: يشكل المديرون فرق عمل لا لتشجيع العمل الجماعي ونشر روح التعاون بين الأفراد وحسب، ولكن للمساعدة في حل الصراعات بين هذه الفرق كي يستطيع أفرادها أداء عملهم بكفاءة وتناغم.
❂بناء ثقافة مؤسسية ناجحة: يلعب المديرون دورًا حيويًا ومؤثرًا في بناء ثقافة مؤسسية قوية تحقق لجميع الأفراد معًا ما يحققه الدور القيادي لكل فرد منهم على حدة. فهي تحثهم على استغلال أفضل إمكاناتهم ومهاراتهم عن طريق المواءمة بين اهتماماتهم واحتياجات المؤسسة. وعلى العكس من عملية اتخاذ القرار كصورة من صور السيطرة والتحكم، تعتبر الثقافة المؤسسية صورة من صور القيادة.
❂توسيع شبكة العلاقات: يعتبر تكوين شبكة علاقات مع أطراف خارجية أمرًا بالغ الأهمية والتأثير. لهذا، يقضي المديرون وقتًا أطول في توسيع شبكة علاقاتهم وتقويتها وعقد تحالفات مع جهات مساندة خارجية.
❂تمثيل الشركة: على الصعيد الخارجي، يلعب المدير دور ممثل الشركة الذي ينوب بصفةٍ رسمية عن قسمه أمام العالم الخارجي، سواء أكان مديرًا تنفيذيًا يدير حفل عشاء رسميًا، أو عميد إحدى الكليات يوقِّع أوراق الخريجين، أو مشرف عمال في أحد المصانع يلقي التحية على العملاء والزائرين والموردين.
❂الإقناع وبث المعلومات: يستغل المدير شبكة علاقاته لمساندة قسمه أو مؤسسته. على صعيد المعلومات، ينطوي هذا على تبادل معلوماته مع أطراف خارجية، كأن يحذر الأمهات القاطنات قرب المدرسة من وجود تجار مخدرات في المنطقة. أما على صعيد الأفراد، فيعمد المدير إلى إقناع الأطراف الخارجية بما هو مهم وضروري لقسمه أو مؤسسته، مثل حث مكاتب المحاسبة على زيادة الميزانية أو استغلال المهرجانات العامة كفرصة لتشجيع المساهمة المجتمعية في تطوير المدرسة مثلاً.
❂الغربلة: بالنظر إلى الأنشطة السابقة، ندرك أن الموازنة بينها جزء لا يتجزأ من فن وحرفة وممارسة الإدارة. فالمديرون ليسوا مجرد قنوات تمر عبرها المعلومات، ولكنهم أيضًا ”صمامات أمان“ تتحكم فيما يعبر وكيف يعبر؛ فالمدير هو حارس البوابة، وغربال للمعلومات والعلاقات التي تتدفق من كل مكان في كل اتجاه.
ثالثاً : صعيد التنفيذ المباشر
إذا اعتمد المديرون على صعيد المعلومات (الإدارة عن بُعد) مع صعيد الأفراد (الإدارة عن قرب)، فإنهم يستطيعون الإدارة على صعيد ثالث وهو إدارة العمل وتنفيذه بأنفسهم وبصورة مباشرة وملموسة.
❂المدير كمشارك في التنفيذ (داخل الشركة): ما هي فائدة مشاركة المديرين في إنجاز العمل؟ معظم المديرين لا يفعلون أي شيء، ولا يجيبون حتى على مكالماتهم التليفونية. إذا راقبت مديرًا في أثناء عمله، فستجده إما متحدثًا أو منصتًا، لا فاعلاً أو منفذًا أو مشاركًا. الفعل الذي نقصده هنا هو أن تنهض من وراء مكتبك لإنجاز العمل بنفسك وبصورة مباشرة، بدلاً من أن يكون ذلك
بصورة غير مباشرة عن طريق تحفيز الموظفين أو تحليل المعلومات.
▼إدارة المشروعات: يُفضِّل المديرون إدارة المشروعات بأنفسهم، أو ينضمون إلى فريق عمل لتنفيذها، وذلك إما رغبةً في تعلم شيء جديد، أو إدارة الآخرين وتشجيعهم على الإنجاز. ولكن، غالبًا ما يكون السبب هو اهتمامهم بالنتائج التي يجب أن تثمر عنها هذه المشروعات.
▼التعامل مع المشكلات: إذا كانت إدارة المشروعات مرتبطة بعوامل المبادرة واتخاذ الإجراءات الوقائية واستغلال الفرص المتاحة، فإن التعامل مع المشكلات مرتبط بالتفاعل والتأقلم مع التغيرات الطارئة. قد تتمثل هذه المشكلات في ظهور حدث مفاجئ أو حدث سبق تجاهله من قبل، أو في ظهور منافس جديد. ولهذا فإن الإدارة نشاط مصمم للتعامل مع الطوارئ؛ فالمديرون يتصرفون عندما تفشل الإجراءات الروتينية المعتادة أو عندما تظهر أحداث طارئة.
❂عقد الصفقات (خارج الشركة): هي الوجه الآخر للمشاركة المباشرة في التنفيذ، ولكن مع الأطراف الخارجية (على الرغم من أن المصطلح يوحي بالفصل بين التعاملات الداخلية والتعاملات الخارجية، مثلn الرئيس التنفيذي الذي يبرم الصفقات ثم يترك تنفيذها لموظفيه). يعقد المدير الصفقات مع أطراف خارجية – مثل الموردين – ولكن أيضًا مع المديرين الآخرين داخل المؤسسة التي يعمل بها. وهناك مقومان لهذا الدور: عقد التحالفات المهنية – أحيانًا يسمى حشد وتكثيف الطاقات – ثم استغلال هذه التحالفات إلى جانب شبكة العلاقات لإجراء مفاوضات حول مشروع أو عمل ما. وختامًا، يجب أن تدرك أن إتقان هذه المهارات كلها لن يجعلك مديرًا كفؤًا، لأن مفتاح المدير الناجح هو مزج جميع جوانب العملية الإدارية بشكلٍ متوازن وديناميكي، وهذا لن يحدث إلا بالتطبيق والممارسة العملية. فما من تدريب أو مدارس أو كتب يمكنها أن تحقق ذلك أو تكون بديلاً عنه، لأن الممارسة هي مفتاح الإدارة الفعالة.
نقلا عن www.edara.com
تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية و” المنظمة الامريكية للبحث العلمي”
برئاسةأم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني

#بناة_المستقبل
#أكاديمية_بناة_المستقبل
#راعي_التنمية_بالوطن_العربي